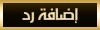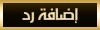التّعريف :
1 - الشّرع ، والشّريعة ، والشّرعة في اللّغة : الطّريق الظّاهر الّذي يوصل منه إلى الماء ، يقال: شرعت الإبل شرعاً وشروعاً : إذا وردت الماء .
والشّرع في الاصطلاح : ما سنّه اللّه لعباده من الدّين وأمرهم باتّباعه .
" ومن قبلنا " هم الأنبياء المرسلون قبل نبيّنا إلى الأمم السّابقة .
فشرع من قبلنا هو : ما جاء به الرّسل من الشّرائع إلى الأمم الّتي أرسلوا إليها قبل مبعث النّبيّ. وحدة الشّرائع السّماويّة :
- الشّرائع السّماويّة كلّها من مصدر واحد ، وهو اللّه سبحانه وتعالى ، فهي لهذا متّحدة الأصول . فلا تختلف في أصول الدّين ، كوحدانيّة اللّه ، ووجوب إخلاص العبادة له . والإيمان بالبعث ، والجنّة ، والنّار ، والملائكة ، وغير ذلك من أصول الدّين .
قال اللّه تعالى لنبيّه : { شَرَعَ لَكُم مِّنَ الدِّينِ مَا وَصَّى بِهِ نُوحاً وَالَّذِي أَوْحَيْنَا إِلَيْكَ وَمَا وَصَّيْنَا بِهِ إِبْرَاهِيمَ وَمُوسَى وَعِيسَى أَنْ أَقِيمُوا الدِّينَ وَلا تَتَفَرَّقُوا فِيهِ } .
اختلاف الشّرائع في الفروع :
3 - الشّرائع السّماويّة قد تختلف في الأحكام الفرعيّة حسب اختلاف الزّمن والبيئات ، وبسبب ظروف وملابسات خاصّة بأمّة من الأمم فتحرّم بعض أمور على أمّة لأسباب خاصّة بها .
كما حرّم على اليهود بعض أجزاء الحيوان ، قال تعالى : { وَعَلَى الَّذِينَ هَادُواْ حَرَّمْنَا كُلَّ ذِي ظُفُرٍ وَمِنَ الْبَقَرِ وَالْغَنَمِ حَرَّمْنَا عَلَيْهِمْ شُحُومَهُمَا إِلاَّ مَا حَمَلَتْ ظُهُورُهُمَا أَوِ الْحَوَايَا أَوْ مَا اخْتَلَطَ بِعَظْمٍ }. ولكن هل نحن متعبّدون بفروع شرع من قبلنا من الأمم ؟ اختلف علماء الأصول والفقه في ذلك. وهل كان النّبيّ صلى الله عليه وسلم يتعبّد قبل المبعث بشرع أحد من الأنبياء ؟ منهم من قال : كان يتعبّد ، ومنهم من نفى ذلك .
وبناءً على هذا الاختلاف الأصوليّ والكلاميّ فإنّ ما هو من الشّرائع السّابقة وإن ورد ما يدلّ على إقراره فهو شرع لنا وإن ورد ما يدلّ على نسخه فليس شرعاً لنا بالاتّفاق .
وإن سكت شرعنا عن إقراره ونسخه فقد اختلف الفقهاء في ذلك :
فذهب الحنفيّة ، والمالكيّة ، والحنابلة إلى أنّه شرع لنا ، ثابت الحكم علينا ، إذا قصّه اللّه علينا في القرآن من غير إنكار ، ولا تقرير ، فلا نأخذ من أحبارهم ولا من كتبهم .
واحتجّوا بقوله تعالى : { وَتِلْكَ حُجَّتُنَا آتَيْنَاهَا إِبْرَاهِيمَ عَلَى قَوْمهِ } ، إلى قوله : { فَبِهُدَاهُمُ اقْتَدِهْ}.
وقوله تعالى : { ثُمَّ أَوْحَيْنَا إِلَيْكَ أَنِ اتَّبِعْ مِلَّةَ إِبْرَاهِيمَ حَنِيفاً } .
وقالوا : إنّ هذه الآيات وغيرها تدلّ على أنّ شرع من قبلنا من الأنبياء شرع لنا ، وهي وإن لم تكن لازمةً لنا بنفس ورودها في تلك الشّريعة قبل مبعث النّبيّ صلى الله عليه وسلم فإنّها قد صارت شريعةً لنا بورودها على شريعتنا ولزمنا أحكامها . بناءً على هذا استدلّوا بها على آراء فقهيّة ذهبوا إليها :
فقد استدلّ الحنفيّة بقوله تعالى : { وَكَتَبْنَا عَلَيْهِمْ فِيهَا أَنَّ النَّفْسَ بِالنَّفْسِ } على وجوب قتل المسلم بالذّمّيّ ، واستدلّوا بقوله تعالى حكايةً عن نبيّ اللّه صالح عليه السلام :{ قَالَ هَذِهِ نَاقَةٌ لَّهَا شِرْبٌ وَلَكُمْ شِرْبُ يَوْمٍ مَّعْلُومٍ } . على جواز قسم الشّرب بالأيّام ، لأنّ اللّه تعالى أخبر عن نبيّه صالح بذلك ولم يعقبه بالنّسخ فصارت شريعةً لنا مبتدأةً .
واستدلّ المالكيّة على جواز الحكم بالأمارة بقوله تعالى : { بَلْ سَوَّلَتْ لَكُمْ أَنفُسُكُمْ أَمْراً } . حكايةً عن نبيّ اللّه يعقوب عليه الصلاة والسلام ردّاً على قول إخوة يوسف : { إِنَّا ذَهَبْنَا نَسْتَبِقُ وَتَرَكْنَا يُوسُفَ عِندَ مَتَاعِنَا فَأَكَلَهُ الذِّئْبُ } .
وبنوا على ذلك أحكاماً كثيرةً :
منها : لو وجد ميّت في دار الإسلام ، وهو غير مختون وعليه زنّار فلا يدفن في مقابر المسلمين، استناداً إلى هذه الأمارة .
وقال الشّافعيّة في القول الأصحّ عندهم : إنّ شرع من قبلنا ليس شرعاً لنا ، وإن ورد في شرعنا ما يقرّره ، وقالوا : إنّ النّبيّ صلى الله عليه وسلم لمّا بعث معاذاً إلى اليمن قال له : » كيف تقضي؟ فأجابه : أقضي بما في كتاب اللّه ، قال : فإن لم يكن في كتاب اللّه ؟ قال : فبسنّة رسول اللّه صلى الله عليه وسلم . قال : فإن لم يكن في سنّة رسول اللّه صلى الله عليه وسلم ؟ قال : أجتهد رأيي « .
ولم يذكر شرع من قبلنا فزكّاه النّبيّ صلى الله عليه وسلم وصوّبه ، فلو كان ذلك من مدارك الأحكام لما جاز العدول إلى الاجتهاد إلاّ بعد العجز عنه .
والله ولي التوفيق .
اللهم لا تجعل حظنا من ديننا قولنا